قد يهمك أيضا
حاورته: سماح ممدوح حسن
في عصرٍ تتزاحم فيه الأفكار المادية على العقول، يبرز الأدب كنافذة للبحث عن الأسئلة الوجودية الكبرى، واستكشاف ما وراء الطبيعة. وما بين الشك والإيمان، والعرفان الفلسفي والتجربة الحياتية، يصدح صوت الروائي والباحث الأردني يحيى القيسي كمفكر وروائي يسبر أغوار العالم الآخر بأسلوب يمزج بين التأمل الروحاني والإبداع السردي.
في الحوار التالي مع «حرف»، نحاول أن نعرف كيف شكّلت التجارب الشخصية والتأملات الفلسفية عماد المشروع الروائي لـ«القيسى»، والذى يفتح أبواب الماورائيات والروحانيات، بداية من روايته «باب الحيرة» التي جسدت ارتحاله بين الشك واليقين، إلى «بعد الحياة بخطوة» التى تطرح رؤية مغايرة للعالم الآخر، وصولًا إلى «حيوات سحيقة» التى تغوص في دهاليز الأرواح والأزمنة.
نتعرف كذلك على رؤيته الفريدة لعلاقة الأدب بالعلم، والقضايا الشائكة مثل التطرف الديني، والجدل حول أعلام التصوف الإسلامي مثل ابن عربى، خاصة مع توازن هذه الرؤية بعيدًا عن التقديس أو النقد الجاف.

■ يركز مشروعك الروائى على القضايا الوجودية والروحانية والـ«ماورائيات».. كيف تشكلت هذه النزعة فى كتاباتك؟
- أصدرتُ ٥ روايات تنشغل بـ«الماورائيات» والظواهر الخارقة، والتضليل الذى طال البشر فى شتى الحقول، وهذا الانشغال يعكس تطور تجربتى الوجودية وانشغالاتى الفكرية بحثًا عن الحقيقة، وهى التجربة التى مرت بمراحل كثيرة، وتبدلات مصيرية على المستوى الفكرى ونظرتى للوجود، والإيمان وعدمه.
بدأت هذه التجربة برواية «باب الحيرة»، التى تعكس فترة الشكّ ووصولى إلى تخوم الإيمان، ثم «أبناء السماء» و«الفردوس المُحرم»، وهى ثنائية روائية بحثًا عن العلوم السرية، والكيانات غير البشرية وأثرها على حياة الناس، وتجسد إعادة تأويل لقصة خروج آدم من الجنة بالمعنى الفلسفى وليس الدينى. إذن، كل هذه الأعمال وما بعدها هى نتاج تأمل عميق، وتجارب حقيقية، وبحث متواصل عن المسكوت عنه والمجهول فى حياتنا، وعسى أن أكون قد وُفقت فى مقاربة هذه الأمور فنيًا كروايات أولًا، قبل أن تكون حاملة لمشروعى الفكرى المثير للجدل.
■ الحياة بعد الموت لطالما كانت هاجسًا للبشرية منذ العصور القديمة.. هل تعبّر روايتك «بعد الحياة بخطوة» عن نفس الهاجس؟
- «بعد الحياة بخطوة» مقاربة لإمكانية وجود حياة أكثر جمالًا فى المرحلة المقبلة من رحلة الإنسان، وهى تنشغل بتجربة «الاقتراب من الموت» التى خبرها الكثير من البشر أثناء الغيبوبة، ولكنها فى الوقت نفسه عمل فنى فلسفى يحاول الإجابة عن الأسئلة الكبرى فى الوجود، خاصة سؤال الموت، والخلود.
من خلال هذه الرواية جربت تقنية سردية جديدة نوعًا ما، إذ لم أخبرها فيما قرأت من الروايات العربية، وهى الكتابة لكلمة أو عبارة قصيرة قد لا تتجاوز الكلمتين، ومن خلال عرض هذه الكلمات المفخخة بالروائح والأمكنة والصور والألوان والذكريات، تنثال عند القارئ تداعيات كثيرة تغنيه عن الكثير من الوصف والجمل الطويلة.
الرواية محاولة لتقديم سردية موازية للسردية الدينية للحياة بعد الموت، لا تناقضها بشكل صارخ، بل تسعى إلى فتح الآفاق لها، ومنح المتلقى الأمل فى عالم تتواصل فيه الحياة بشكل أكثر جمالًا ونورًا.
■ شهدنا على مر العصور انخراط الكثير من علماء العلوم التطبيقية فى مسائل روحانية.. فى رأيك، ما سر هذا الاهتمام؟ وهل ترى تشابهًا بين استكشاف الروحانية فى الأدب والعلوم؟
- كشف الأسرار والبحث عن الحقائق المغيبة مسألة تشغل الإنسان منذ عصور سحيقة، والروحانيات حقل خصب لمثل هذه البحوث، وأذكر فى هذا السياق التجربة المصرية خلال الخمسينيات والستينيات من القرن الماضى مع الدكتور رءوف عبيد، وكتبه المفصلية مثل «الإنسان روح لا جسد».
لكن حدث تراجع فى الروحانيات والبحث فيها بعد ظهور «الإسلام السياسى»، فى ظل طبيعته الجافة التى تخلو من الروحانيات، فتراجعت البحوث الروحانية التى كانت متميزة فى مصر والعراق تحديدًا، حتى وصلنا إلى ما نحن فيه اليوم من اعتماد على المنتج الغربى فى هذه المسائل.
بالنسبة لى، حاولت مزاوجة العلم مع الروحانيات، وأرى أنه لا يوجد تناقض فى واقع الأمر بين العلوم الحديثة خاصة «فيزياء الكم»، والظواهر الروحانية التى تحدث عنها المتصوفة المسلمون، أو ذكرها أصحاب التجارب والخوارق من المعلمين الهنود وحكماء التبت وغيرها، وأرى أنه من الضرورى مواصلتنا فى هذا الطريق الطويل والشائك والشائق معًا.
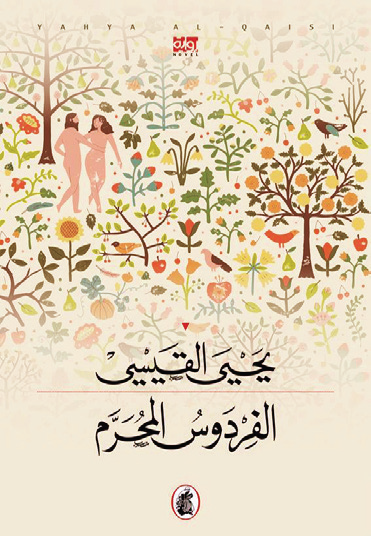
■ الروحانية فى الشرق تميل إلى التأمل والانفصال عن المادة، بينما تقترب فى الغرب من «الميتافيزيقا» والفلسفة.. كيف ترى تأثير هذه النزعات المختلفة على الأدب؟
- يعد الأدب موئلًا للكثير من الخبرات الروحية، وهذا الأمر لا ينطبق على الشرق فحسب، بل هناك جمعيات وكتابات كثيرة فى الغرب تنشغل بالروحانيات، علينا ألا ننسى تجربة باولو كويلو مثلًا فى رواياته الكثيرة، أو دان براون أيضًا الذى تقوم رواياته على البحث والتقصى فى عالم الروحانيات. صحيح أن الغرب انشغل أيضًا بالفلسفة وتعميقها بعيدًا عن العرفان الشرقى، لكنه كان متسامحًا مع من يخوض غمار الكتابة فى «الماورائيات»، ولم ينكر عليهم ذلك.
بالنسبة للشرق فهو ليس واحدًا، فالصين شرق أيضًا، والهند وإيران وروسيا، وكل دولة لديها انشغالاتها الخاصة فى هذا الجانب، لكن العرب، وهم أيضًا محسوبون على الشرق، لم ينشغلوا كثيرًا خلال القرن العشرين بالعجيب والغريب فى الأدب، بل بقيت خبراتهم محصورة فيما ورد قديمًا بكتب المتصوفة، و«ألف ليلة وليلة».
■ تتناول روايتك «حيوات سحيقة» فكرة حلول الروح فى أجساد مختلفة عبر العصور، وهى من الموضوعات العميقة والمعقدة.. كيف قدّمتها داخل السياق السردى للرواية؟
- فى روايتى الخامسة والأخيرة «حيوات سحيقة» وظفت فكرة الوجود السابق للإنسان فى رحلته الأرضية عبر العصور، ليس الأمر من قبيل تناسخ الأرواح أو الحلول، بل يتعلق برحلة النفس ذاتها فى أجساد أخرى، أو «لبس قمصان جسدية» فى عصور ماضية، وقد انشغلت بهذا الأمر فنيًا، إذ ليس المقصود الترويج لهذه الفكرة أو دعوة القارئ للإيمان بها، بل بمرونتها وقابليتها للتوظيف فنيًا، حتى تتمكن الشخصية فى الرواية من الولوج إلى أزمنة كثيرة، ونقل ما تم فيها على لسانه، مثل طوفان نوح ومأساة الحلاج وغيرهما. كما أن الرواية تدين التاريخ القائم على العنف، الذى وصلنا سواء من أجدادنا السابقين فى كتبهم، أو ما صنعه الغرب أيضًا من مجازر للنساء باسم محاربة «الساحرات».
من جهة أخرى، تناولت الرواية شخصية «بيركهارت» السويسرى، الذى جاء إلى البترا فى عام ١٨١٢، وتفاصيل رحلته، فى محاولة للكشف عن ثنائية الشرق والغرب، واللقاء بينهما على أسس من البحث أو التجسس كما كان سائدًا حينئذٍ.

■ تطرقت الرواية إلى موضوع التطرف الدينى.. فى رأيك، إذا كان المتطرفون يستطيعون اجتذاب بعض الأشخاص لأسباب معينة مثل الفقر والجهل، كيف ينجحون فى تجنيد أشخاص مثل الأطباء أو الأثرياء؟
- الرواية كعمل أدبى فى رأيى يجب أن تضىء ولو شمعة وسط الظلام، وتنشغل بالتنوير، ونقد الجانب المظلم مثل التطرف والانغلاق ومحاربة الجهل والفساد، وطبعًا كل ذلك دون أن تفقد الرواية هويتها الفنية، ولغتها السلسة وتقنياتها الحداثية، فليس المطلوب أن تتحول إلى بيان سياسى أو وعظ ممجوج.
لقد ناقشت مسألة التطرف الدينى فى «حيوات سحيقة» من خلال بعض الشخصيات التى تورطت بالعنف على أساس الفهم الخاطئ للدين، والذى قد يسهم فى جر أشخاص عديدين إلى التورط فى هذا الفهم، وبالتالى تقسيم العالم إلى فسطاطين: الإيمان والكفر.
ولدينا فى التاريخ جذور أو منابع للفكر الإقصائى والتطرف، ولا يتعلق الإيمان بالذكاء ولا بالتخصص، فهو شىء يسرى فى القلب، لا تفسير له من منطق، فقد تجدين رائد فضاء هنديًا يعبد فأرًا، أو عالم رياضيات غربيًا يعبد الطبيعة، وغير ذلك. المشكلة ليست فى الإيمان بل فى محاولة تطبيق ذلك عمليًا، وبدء فرز البشر بشكل إقصائى، وأن بعضهم يجب القضاء عليه لأنه لا يشارك الآخرين الإيمان نفسه، وكذلك توزيع «صكوك الغفران» بمن يذهب إلى الجنة أو النار، وهنا تكمن المصيبة.
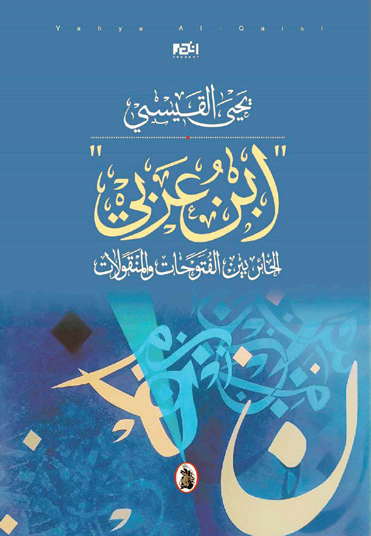
■ فى كتابك «ابن عربى الحائر بين المنقولات والفتوحات» تناولت آراء مختلفة حول ابن عربى، بين المدح والتقديس، أو النقد والتجريح.. كيف عالج الكتاب هذا التباين؟
- انشغلت بقراءة كل ما وقع تحت يدى من كتب الشيخ ابن عربى، على مدار سنتين متواصلتين، وهى قراءة متأنية ودقيقة فى محاولة لفهم فِكر هذا الرجل الذى يعده الصوفيون «المعلم الأكبر» لهم، وقد هالنى أنه يرفع نفسه إلى مقامات تفوق مقامات الأنبياء، وله كرامات مثلهم، وحصلت له المعجزات نفسها، حتى إن له معراجًا يشبه معراج النبى العظيم، عليه السلام، وفى الوقت نفسه يورد أنه لا يخرج من عباءة الأنبياء، وأنه يؤمن بالحقيقة المحمدية.
بالتالى، اكتشفت تناقض الرجل بين ما يسمى بـ«التنزلات الإلهية» عليه أو «الفتوحات»، وبين ما ينقله من الآخرين، خاصة بعض الأحاديث التى ينقلها كما هى دون أن يعرضها على القرآن، فيظهر التناقض واضحًا. وقد ساهم هذا الخلط فى الكثير من الإساءات للنبى العظيم، ذكرتها بالتفصيل فى هذا الكتاب، وربما أعود قريبًا لإصدار جزء جديد مما اكتشفته عن هذا الصوفى الشهير، حتى تكون الصورة واضحة لمحبيه وكارهيه، والأهم فى الأمر أننى لم أقع تحت وطأة تقديس الرجل كما يفعل الكثير من تلامذته ومحبيه، ولا تورطت فى تدنيسه، بل حاولت أن أكون محايدًا لتقديم رؤية مختلفة وهادئة لتجربته.
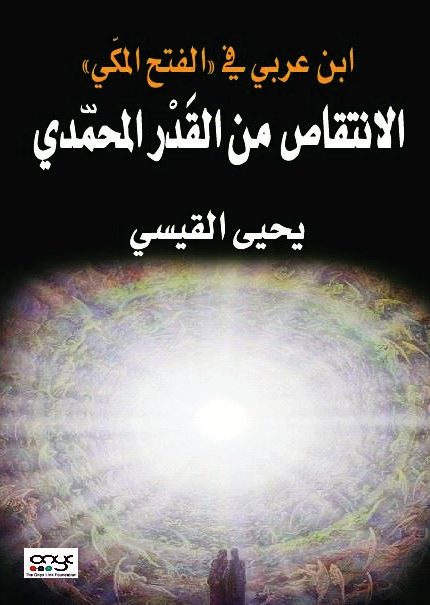
■ كتبت الرواية والقصة القصيرة والبحث الأكاديمى.. أى من فروع الإبداع هذه كانت الأصعب؟
- جربت الكتابة الأدبية والصحفية والبحثية والتلفزية، فالإبداع نهر قد يتخذ مسارب متعددة، وقد يكون مزاج الكاتب نحو القصة القصيرة، ثم يتجه نحو الرواية، وهكذا، وهذا يعكس المراحل المختلفة التى يمر بها.
أنا مثلًا بدأت قاصًا، ثم مع توسع آفاقى والتبدلات الفكرية التى طرأت علىّ، وزيادة خبراتى الحياتية، أحسست أن القصة القصيرة لم تعد تتسع لما فى أعماقى من عوالم، لهذا اتجهت نحو الرواية، ولم أستطع العودة إلى القصة القصيرة.
وبعد ٥ روايات شعرت بأن البحث يستهوينى، لأن أفكارى اتسعت كثيرًا، وصار ثوب الرواية لا يستوعبها، وأنا حاليًا فى هذه المرحلة، وأرى أنها مرحلة مهمة فى تجربتى، وتعد بالكثير بعد أن نضجت أدواتى واتسعت تأملاتى، وأتمنى أن أخرج من هذه المرحلة بما يفيد.
■ نشرت مؤخرًا توصيات عديدة لمن أراد الكتابة الإبداعية، وتقول إنك خرجت بها من خبرة 37 سنة كتابة، ما أهم هذه التوصيات؟
- لا يمكن اختصار أكثر من 20 توصية فى جواب هنا، أتمنى نشرها على نطاق واسع لمن يرغب فى التعرف عليها من الجيل الجديد، لكنها تتعلق بضرورة القراءة الكثيرة والكتابة القليلة من قِبل المُقبِل على الأدب، وعدم التورط فى «الجمل المعلبة» و«الكلاشيهات»، ومنح الشخصيات القصصية أو الروائية بعض الديمقراطية دون لىّ عنقها، وعدم تدخل الكاتب فى حركتها الطبيعية، وانسجام الحوارات مع عمر الشخصية ونوعيتها، وغير ذلك الكثير من الخلاصات التى تنفع للمحترف كما للمبتدئ.
___
المصدر: حرف


إرسال تعليق